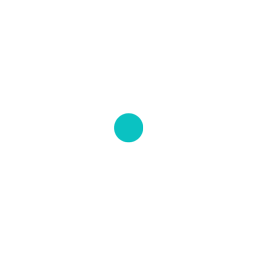
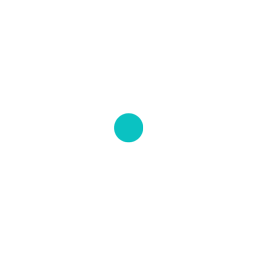
مقالات ادبية واجتماعية وفنية
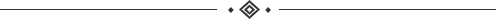
عبدالنبي عبادي/ كاتب مصري
أحمد حافظ شاعرٌ مصريّ من جيل الشّباب، هو من مواليد ١٩٩٥م بمحافظة الفيوم، صَدَرت له مجموعتان شعريتان هما "سلاما أيها الجبلُ" عن دائرة الثقافة بالشّارقة ضمن سلسلة إبداعات عربيّة عام 2018م و "قلبي ثلاجةُ موتى" عن مؤسسة موزاييك للدراسات والنشر في إسطنبول بتركيا عام 2022م. نال أحمد حافظ أكثر من جائزة داخل مصر وخارجها، كان أحدثها جائزة الدّولة التّشجيعيّة في الشعر عن مجموعته الشعرية "قلبي ثلاجة موتى".
يجمع الشاعر في "قلبي ثلاجة موتى" بين الشعر العمودي وشعر التفعيلة، وقد جاء الديوان في ١١١ صفحة من القطع المتوسط وهو الديوان الذي ستكون وقفتي معه ساعيا لمحاولة استبصار مستويات التلقّي فيه.
مدخل : تلقّي الشّعر المُعاصــر:
لطالمَا تعدّدت التُّهم الموجهة للحداثة في الشّعر، لكنّ حِدّة تلك التُّهم تتراجع شيئا فشيئا تحت وطأة الزّحف التكنوهَمجي(1) وانهيار سدود العُزلة بين الثّقافات والمُجتمعات وغزارة التّراكم المعرفي وسيولة الواقع الأدبي التي جعلتْ أي خِلاف في قضيّة فنيّة مسألة وقت، فما إن تقفز إلى السّاحة الثّقافيّة العربيّة قضيّة من القضايا حتّى تمحوها قضيّة لاحقة ما تفتأ تنمّحي دون أن نصل إلى أي شيءٍ لا في السّابق ولا في اللاحق!
وقد كان الاتّهام الأبرز لشِعر الحداثة هو (الغموض) الذي أوشَكَ أن يحذف (القاريء) من مُعادلة التلقّي أو ربّما أقولُ إن ذلك (الغموض) ظلّ يبحثُ عن قارئ مُحتمل لا يأتي القصيدة بشروطه المُسبَقة، بل ينصاعُ لشروط القصيدة الجديدة ويُصغي لها. وحتّى لا أُسرِفَ في الوصف والتنظير وحَكي المَحكيّ، فقد وجدتُ أنه من الضّروري قبل أن أكُتبَ عن (مستويات التلقّي في ديوان "قلبي ثلاجة موتى") أن أعرض لمفهوم "التلقّي" الاصطلاحي حتّى يتمكّن المُتلقّي الكريم أن يُتابع معي مستويّات ذلك التلقّي في الدّيوان محطّ القراءة.
ربّما نجح "أرسطو" مُبكّرا في الالتفات إلى موضع المُتلقّي من مسألة الإبداع عندما تحدّث عن "التطهير" كأحد غايات فنّ الشّعر قاصدا بذلك أثر الشّعر في (القارئ-المتلقّي) ومن ثمّ لا يُمكنُ فصل الشّعر-وفق أرسطو- عن وظيفته السّابقة وبالتالي لا يُمكن تجاهل (المُتلقّي) بينّما ظَلَ مفهوم (التلقّي) عصيّا على التّحديد والتأطير لأسبابٍ كثيرة منها تشابك مفاهيم مثل "التأُثير" و "التلقّي" و "الاستيعاب" وهو مبحثٌ طويلٌ سَبَق إليه عبدالقادر الجرجاني عندما تحدّث عن دور المُتلقّي قائلا : (حيث تنظر بقلبك، وتستعين بفكرك، وتعمل رَويَّتك، وتراجع عقلك، وتستنجد في الجملة فهمك) (2) ويذهب الدكتور غازي مختار وعرفان الأشقر في كتاب (الأدب الجاهلي) إلى تعريف التلقّي في المُصطلح النّقدي كالتالي:
(أن يستقبل القارئ النص الأدبي بعين الفاحص الذواقة بغية فهمه وإفهامه، وتحليله وتعليله على ضوء ثقافته الموروثة والحديثة، وآرائه المكتسبة والخاصة في معزل عن صاحب النص.)(3) إذن فالحديثُ هنا هو عن دور القاريء حيال النّص الشّعري (أو حسب الجنس الأدبي) وما يقوم به من استقبال وقراءة وتأويل للنصّ الشعري بمعزلٍ عن الشّاعر. ولمّا تطوّرت القصيدة العربيّة، كان لا بد أن يواكب ذالك التطوّر في الشّكل والمضمون تطوّرا في ذائقة المُتلقّي، لكنّ ذلك لم يحدُث، أي أن ذائقة المُتلقّي لم تتطوّر بالشّكل المطلوب لأن الشّعراء والنّقّاد والمثقّفين الذين تطاحنوا وتلاسنوا حول طبيعة الشّعر وتقديم شكلٍ على آخر فيه جعلَ القاريء في حيرة من أمره ثمّ فاجأته القصيدة الحداثيّة بغموضها-المُصطنع في كثير من الأحيان- فانصرفَ كثير من القرّاء عن الشّعر كلّه!
وعليّ هُنا أن أذكّرك-أيها المُتلقّي الكريم- أن متلقّي الشّعر العربي مرّ بمرحلتين مركزّيتين في تلقّي الشّعر العربي وهُما (التلقّي الشّفاهي\الشّعر المنبري) ثمّ القراءة (الشّعر المنبري-التفعيلة-النّثر) ليخوضَ نفرٌ من القرّاء في عصرنا هذا مرحلة ثالثة من التلقّي وهي (التّفاعليّة: أي قراءة النص والمشاركة في كِتابته وتطويره فيما سُمي "قِراكِتابة").
وقدْ يكونُ عزوف القاريء المُعاصر عن قراءة الشّعر هو ما دفع عدد كبير من الشّعراء الشّباب إلى كِتابة القصيدة العموديّة في مُحاولة لاستئناس القاريء المُعاصر أولا ثمّ فتح أبواب التلقّي أمامه ثانيا.
أوّلُ ما يلفت نظر المُتلقّي- أنا وأنتم- في المجموعة الشعريّة "قلبي ثلّاجة موتى" هو التوتّر الدّلالي الذي تخلقه الكلمات الثلاث (قلبي- ثلاّجــة – موتى) والذي يخلق مسافة غير آمنة للسّير بين الذّات والموضوع؛ فبينما يُحيلُنا "القلبُ" إلى الشّاعر بوصفهِ ذاتا، تُحيلُنا "الثلاجة" إلى "الموتى" بوصفهم موضوعا وهذا هو أوّلُ "فخّ" عَليَ كمُتلقٍ أن أتجنّبَهُ لأن القراءة اللاحقة للمجموعة الشعريّة تكشفُ لنا أن "القلب" استُخدِم فنيّا كذاتٍ وكموضوعٍ في آنٍ واحدٍ في انسجامٍ فنّي يخفّف شيئا فشيئا من حدّة التّوتّر الدلالي للعنوان.
يكفي أن أُشيرَ إلى أن لفظة "قلب" وردت في التّصديــر وحده أربع مرّات، وهو التّصديــر الذي آخى بين التّفعيلة والنّثر لأنّهما اشتركتا في بثّ شكوى "القلب" ومن ثمّ يبدو "القلب" بؤرة دلالية لكل من "العنوان" و "التّصدير" الذي جاء على هذه الصّورة:
تصديـــر
عاشَ مُنتصبًا
بينما.. ينحني القلبُ يبحثُ عمًّا فقدْ.
أمل دنقل.
في قلبه ضجيج، كأنَ في قلبه مسافرين يحتفلون في حافلة، ولا يعرف حافلةً، ولا مُسافرينَ، ولا يدري أنّ في قلبِهِ طريقًا.
وديع سعادة.
وبهذا التّصديــر نقلَنا الشّاعر من "القلب" بوصفه ذاتا إلى القلب بوصفه موضوعا للمجموعــة الشعريّة التّي تُشرّح شواغل ذلك القلب وتفضح محتوياته المُقسّمة في حُجرات أبوابها (باب القلق وباب الخروج وباب السؤال وباب الحنين وباب السُّكون) ولكُلّ بابٍ منها طَرْقُ ولكلٍ منها مفتاح!
أظنُّ أن الشّاعرَ قد أنجزَ مسافةً جماليّة ممتدّة بين أفق النصّ وأفق المتلقّي عن طريق كسر أفق التوقّع من خلال استحضار الموت كمُعظى تاريخي محرّض على التأمّل والاستلهام أكثر منه كونه مُعطى يوميا محرّضا على الحُزن والبُكاء؛ وبلُغة أقرب أستطيعُ أن أقول إن الشخصّيّات التي استحضرتها نصوص حافظ بشكل مُباشر أو غير مُباشر هي شخصيّات "فنيّة" بالدّرجة الأولى مع اختلاف صنوف إبداعهم وفلسفتهم الحياتية المنبثقة من بوتقة الدّين ونقيضه أو بوتقة الفكر والثقافة. في الوقت الذي قد يتوقّع القاريء "قلبا" يحتفي بالرّاحلين من المُقرّبين من أهلٍ وأصدقاء نجد أن "قلب الشّاعر" يحتفي بأبناء سلالته من أهل التأمّل والإبداع.
على خمسة أبواب يوزّع الشّاعر قصائده، فمن باب "القلق" إلى باب "الخروج" ومن باب "السؤال" إلى باب "الحنين" ثم إلى باب "السّكون". ولعلّ تقسيم المجموعة إلى "أبواب" يجعلُ من المجموعة الشعريّة مشروعا فنيّا هندسيا سبق تخطيطه الشروعَ فيه وعُرفَ من البداية كيف تكون صورته النّهائية. هذه "الأبواب" هي من ناحية "تبويبات" لموضوعات القصائد وهي من ناحية أخرى "أبواب" ثلاجة الموتى التي حفظ فيها الشّاعر الرّاحلين من شعراء وفنانين وفلاسفة.
والباب يردّنا ردّا جميلا إلى فناء التصوّف، لا سيّما وأن الشّاعر يبدأ بباب "القلق" ويختم بباب "السّكون" وبين القلق والسّكون يضيعُ العشق أو يكونُ كما قال ابن عربي : "الشوق يسكن باللقاء و الاشتياق يهيج بالالتقاء لا يعرف الاشتياق إلا العشاق من سكن باللقاء قلقه فما هو عاشق عند أرباب الحقائق من قام بثيابه الحريق كيف يسكن و هل مثل هذا يتمكن للنار التهاب و ملكة فلا بد من الحركة و الحركة قلق فمن سكن ما عشق كيف يصح السكون و هل في العشق كمون هو كله ظهور و مقامه نشور".
ثمّ يجيء ذكر الباب في القصيدة الأولى من المجموعة الشعرية، وهي قصيدة "وقوف" حيثُ يقول:
"وقوفًا
على الحُلم الذي ردّ بابَهُ بوجهي
وروحي مُهدرٌ عند بابِهِ"
وهو ما يكشفُ لنا موقع الشّاعر من الباب، فهو ليس بالدّاخل وإنّما هو خارج الباب وبالتالي هو بعيدٌ عن فكرة الاستقرار والكمون، بل هو متوترٌ قلقٌ أبدا، دائم الطّرْق بحثا عن إجابة أو مُستقرّ، يقول الدّكتور محمد عبدالباسط عيد "ربما لهذا المعنى فكّر الإنسان في الباب الذي يُغْلق عليه رَحِمَه، ويمنحه الفرصة للتخفف مما يجري بالخارج. الباب يمنحنا تلك الخلوة المؤقتة التي تضبط إيقاع الجسد في علاقته الفكرية والرُّوحية بالمكان، لا تتكون العقائد والقناعات بعيدًا عن مثل هذا الوجود الفرديّ المنعزل؛ حيث يمكننا المراجعة والتّأمل واختبار التفاصيل والتصورات الخاصة والعامة، لا يمكننا فعل ذلك ونحن خارج الباب؛ ففي الفضاء العمومي نغدو وحدة من جسد أكبر، نغدو جزءًا من بناء شاهق اسمه الجماعة بميراثها وعاداتها وتقاليدها، حيث لا يمتاز صوت عن صوت، وحيث تتوارى الشكوك الفردية خلف هيمنة التعميم الذي يوفرّه لنا الوجود ضمن الكتلة البشرية التي ننتمي إليها.."(4)
.. يجيء "الباب" صاحبُ الدلالات الكثيرة والمُتناقضة في المجموعة الشعريّة ص 15، ص16، ص21، ص40، ص101. يقولُ الشّاعر في قصيدة "بُكائية" ص15 و 16:
ها أنا لا حُلمَ في عينيّ أحملُهُ
وآمُلُ أنْ يحقّقه غدٌ..
لا بابَ واربه الأحبةُ كي أعودَ
ولا صُراخي سوف يُشعلُ ثورةً..
فتأملي وجهي المُهدّمَ كالطُّلول
وأجّلي ميعادّنا لمساءِ يومٍ آخرٍ
حتّى أفكّر في الذي سأقول:
عن عينيكِ حين تُعريّاني من ظنوني
عن لياليّ الطويلةِ
عن دمي المسفوكِ في شتّى الممالكِ
عن رصيفٍ غير مقتنعٍ بأسمالي
وعن عمري الذي أنفقتُهُ بددًا على بابِ العدالةِ..
أجّلي ميعادنا لمساءِ يومٍ آخرٍ.
في هذه "البُكائيّة" يجيء ذكرُ الباب في موضعين كما هو مُتضّح لمن سيقرأ، والبابُ هُنا أداةٌ للمنح والمنع ودلالاته كثيرة. لكن قبل أن أقولَ لكم ما في خاطري، أعودُ بكم إلى القصيدة التي سبقتْ القصيدة التي أنا بصدد الباب فيها، ففي ص 11 وردت قصيدة "وقوف" والتي بدأها الشّاعر بقوله:
وقوفًا
على الحُلم الذي ردّ بابه بوجهي
وروحي مُهدرٌ عند بابِه
حتّى تُختتم القصيدة بقوله :
ولو أن ما بي بامرىء القيسِ
لانحنى
ومَرَ على أطلالهِ غيرَ آبِهِ!
فهو يُنكرُ على "امرىء القيس"- صاحب المعلّقة المشهورة- وقوفه على الطّلل (قِفا نبكِ من ذِكرى حبيبٍ ومنزل..) ثمّ يؤكّد موقفه ذلك في القصيدة اللاحقة "بُكائية" ويؤكّد في مطلعها استهانته بالطّلل أو ربّما خوفه منه، فيقول في مطلعها:
طللٌ وذكرى..
لا وقوفَ ولا بُكاء على منازلَ فارغاتٍ
سوف أرسُمُ صورةً للأمس واضحةً
وأمضي غير مُكترثٍ بشيء.
لكنّ هذا الرفض الظّاهري لما هو طَللَ كشف لي أن الشّاعرَ استبدَل الطلل القديم (منزل وسكن الأحباب) بطلل ذي دلالات جديدة، وبالتالي ليس اعتراض الشّاعر على الظاهرة الشّعرية القديمة، ولكنّ الشّاعر يُقدّم للمُتلقي نفسه كَطَلل:
فتأمّلي وجهي المهدّمَ كالطّلول
فالبُكائية ليست على الرّاحلين وإنّما هي مرثيّة للنّفس:
مخذولا بما يكفي أجرُّ خسائري
وأقولُ"
"أيامي سجائرُ أشعلَتْها صرختي الأولى
وأحلامي دُخانٌ عالقٌ في الجو.."
ومردُّ ذلك الانقلاب في مفهوم الطّلل هو اختلاف العصر وتراجُع قيمة "المكان" لدى الشّاعر؛ بمعنى أن الانتقال من زمنٍ تُشكّل الخيمة والصحراء فيه فضاءات مكانية إلى زمنٍ يكتسب المكان فيه صبغة "كونية" نتيجة ذوبان الحدود، فصارَ الشّاعرُ طًللا كما لو أننا نتعامل معه بوصفه "مكانا" مرّت من خلاله الحوادث وتصاريف الدّهر، يقول الشّاعر في قصيدة "صلاة" ص 33:
وأمشي..
فلا ألقى الذين أُحبّهم
وأبكي فلا ألقى بقايا المنازِلِ!
أعودُ للبابِ الذي قُلنا أن الشّاعر ذكره أكثر من مرّة (خمس مراتٍ تقريبا) كالآتي:
في قصيدة بُكائية (في مقطعٍ ذكرتُهُ أعلاه) يقول:
لا بابَ واربه الأحبةُ كي أعودَ
ولا صُراخي سوف يُشعلُ ثورةً..
ثمّ يقول: (.. وعن عمري الذي أنفقته بددا على باب العدالةِ..)
في قصيدة" لا أحد سيأتي "، يقول:
(فلأغلق خلفي الأبوابَ
وأتركُ رائحتي كالقطّةِ في البيتِ
لتحرُسه من غول النّسيان)
في قصيدة "تُطل طلولي علي" ص40 :
سأغلقُ بابي ورائي وأحكم قبضته
وأغادرُ..
ما زالَ في الأرض منأىً
وما زالَ في البئر ماءٌ لأُسرجَ راحلتي.
في قصيدة "هكذا هكذا" ص101، يقول:
في صباحٍ كهذا
على نقرةِ الطّيرِ فوق النّوافذِ
والنّورُ ينسلُّ من فُتحةٍ خيطُهُ
أتثائبُ نصف تثاؤبةٍ
وأردُّ على كسل القلبِ مليون باب.
قد يُثيرُ دهشة المُتلقّي ذلك الذّكر المتكرر للباب وبالتالي يسأل نفسه: هل كانت دلالة الباب واضحة وواحدة دائما؟ أستطيعُ أن أُخبركم عن مُلاحظتي الطّريفة هُنا وهي أن الشّاعر يُطلُب فتح الباب كُلّما كان الباب يخصّ الآخرين، بينما يُغلقه بإحكام إذا كان يخصّه! فهو (يردّ على كسل القلب مليون باب) و (يُحكمُ قبضته) ويقول أيضا (فلأغلق خلفي الأبواب)، فهل يبحث الشّاعر لدى الآخرين عمّا يُخفيه هو أو يخافه؟
كما أستطيعُ أن أذكّركم أن الشّاعرَ نفسه قال في نصٍ له خارج هذه المجموعة الشعرية:
لا أطرقُ بابا مرتين، هكذا عوّدتُ يدي.
الباب الذي لا ينفتح لي من أوّل طرقة
أقطع شجرته من بالي.
وبالتالي تبدو علاقة الشّاعر بالباب علاقة إشكالية، فهو أداة "التكثيف" لديه والتي يصوغ من خلالها هواجسه ومخاوفه في مواجهة آماله وتطلعّاته وهو "رمز" للعقبات التي تنهض في طريقه كما أنه يُشيرُ إلى أن ثمّة (مواجهة) دائمة يخوضها الشّاعر دائما مع ذاته ومع الآخر، فالباب نقطة التقاء طرفين، الشّاعر والآخر الذي يفتح له من ناحية، والشّاعر وذاته التي يستكشفها من ناحية أُخرى. في الحالتين تظل المواجهة قائمة ومتجددة، ألا يكفي أننا نقرأ "باب" من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين لكي نعرف أننا حيال سرّ كبير؟!
- التلقّي وفق مُحيط النصّ:
اعتَمَدَ الشّاعرُ خِطابا موازيا للنصّ المركزي من بداية المجموعة الشعريّة وحتّى نهايَتَها، وهو ما يَضعُ المُتلقّي في مُقابلة دائمة مع مساراتٍ مُتشعّبة للنصَ المُحيط أو ما يُسمّي بالمُتعاليات النصيّة من ناحية، ومسارات النصّ المركزي (القصيدة) من ناحية أُخرى. لقد شكّل كلُّ مُفتتحٍ وضعه الشّاعرُ قبل كل قصيدة مؤلّفا ضمنيا في مواجهة قارئ ضمنّي أيضا سعيا معا لملء الفجوات وتشكيل مساحة تلقّي.. كيف حَدَث ذلك؟
لقد عبّر الشّاعر عن نفسِهِ بوصفِهِ (مُتلقيًّا) من خِلال العِبارات والجُمل الشعريّة التي وضعها قبل النّصوص ثمّ عبّر عن نفسه بوصفِهِ (شاعرا) من خلال القصائد نفسها.
في قصيدة "لا أحد سيأتي"، يضع الشّاعرُ مُفتَتحا قولَ البُحتري "كِلانا ذئبٌ يُحدّثُ نفسَهُ.." وهي قصيدة من بحر الطّويل، يقولُ فيها الشّاعرُ العبّاسي:
كِلانا بها ذئبٌ يُحدّثُ نفسه
بصاحِبِه والجَدُّ يُتعسُهُ الجَدُّ
عوى ثمّ أقعى وارتجزتُ فهِجتُه
فأقبَلَ مثل البرقِ يتبعه الرّعدُ
وكأن مواجهة "البُحتري" للذّئب في معركتِهِ التي وصفها في القصيدة المذكورة هي نفسها مواجهة الشّاعر للذّات في قصيدة "لا أحد سيأتي"، لكنّ الشّاعر لن يتُركك تستسلم لهذا الطّرح وحده وتهنأ بالإمساك بهذه العلاقة لملء الفجوة بين أفق ما تتوقعه وما يكتبهُ الشّاعر، فترجع لتسأل نفسك وما علاقة "فينسنت فان جوخ الرسّام الهولندي الشهير بذلك؟
إن ما تميّز به "فان جوخ" من عُنف في استخدامه للفُرشاة وكأنّه في معركة مع "اللوحة\الذّئب" التي تفضحه، فتقتله! هو العلاقة التي يُمكن أن تُلقي بظلالها على النصّ كخطوط "فان جوخ" الحادّة والمِقدامة الجريئة حتّى يظهر الذئب في قصيدة أحمد حافظ قائلا:
الغُرفةُ هادئةٌ
وعواءٌ يأتيني من أقصى صحراءٍ في الرّوحِ
يُجرّحُ صمتي
لا أملكُ إلا مزماري وفمي
وكتابًا يحكي عن تاريخِ الغابةِ والإنسانِ
وأحجارا آكُلُها وأكلّمُها
وسجائرَ بالكادِ ستكفي لأُسلّي وقتي..
هي مُعاناة الكِتابة ومُعاشرة الفن التي أحرقت "فان جوخ" من قبل، تؤرّقُ من جديد الشّاعر الذي لا يملكُ إلا مزماره\شعره وتاريخه مع الغابةِ والحجر. والشّاعرُ وحيدٌ كفان جوخ في لوحته "ليلة النّجوم"
أستطيعُ أن أقول إن النصّ المُحيط أو ما يسمونه "العتبة النصيّة" يؤدّي وظيفة شبيهة بوظيفة "الهايبرلينك" أو الارتباط فائق السرعة الذي ينتقلُ بك من صفحة على الإنترنت إلى صفحة أُخرى لها علاقة بالنص المركزي الذي تقوم بقراءته، هي فِكرة كالإحالة والالتفات، قادرة على خلخلة ركود التلقّي أو عتمة النّصوص أو مُراوغة المتلقّي حتّى حين!
- تشكيل الموت بين محمود درويش وأحمد حافظ في قصيدة "وجوهٌ جمّةٌ وجهي":
لا أستطيعُ أن أتخيّلَ شاعرًا يكتُبُ مُتجاهلا الموت أو غير آبه به؛ فالموتُ هو ظلُّ الحياة، يتبعُها ويُتابِعُها إلى أن تجيء لحظةٌ تتداعى فيها تشكيلات الحياة أمام زحف تشكيلات الموت. في قصيدته التي جاءت ختاما للمجموعة الشعريّة التي بين يديّ وهي قصيدة "وجوهٌ جمّةٌ وجهي"، يبدو القارئ أمام رجعٍ لصَدى الوجع الممتدّ من بداية المجموعة الشعريّة حتّى خِتامها؛ فبعد أن تلمّستُ معكم كيف أن قلب "الشّاعر" صار ثلاجة موتى وكما ذكرتُ أن الشّاعر انتقل بالقلب بوصفه "ذاتا" إلى القلب بوصفه "موضوعا" وتعامل مع الموت كمُعطى تاريخي جَمالي قابل للتأويل، أقول الآن أن "الوجه" أيضا عاد ليؤدّي وظيفة ضديّة تفرضُ على القارئ إعادة النّظر في المجموعة الشعريّة من بدايتها حتّى نهايتها.
عرفتُ-معكم- كيف صار القلبُ حاضنة للرّاحلين من بشرٍ؛ فنانين وكتّاب وشعراء وفلاسفة ومتصوّفة، فالقلبُ قام مقام (الذّاكرة) إلا أن وظيفته تخطّت (استدعاء) الأسماء والأحداث إلى استدعاء العاطفة واللحظة الجمالية و(تجميدها) لتظلّ طازجة، وقابلة للحضور عند الحاجة، بينما يجئ "الوجه" في نصّه الأخير "وجوهٌ جمّةٌ وجهي" ليؤدّي وظيفة "بعث" لهؤلاء الموتى بشكلٍ ما.
لقد تقاطع الشّاعر أحمد حافظ مع الشّاعر محمود درويش في تصوّراته عن الموت والحياة، فالخطاب الشّعري في قصيدته "وجوه جمة وجهي" تشكّل وفق حضور "الموت" وجها لوجه في مُقابلة مع صاحب "ثلاجة الموتى"، بمعنى أن لحظة دخول "الشّاعر" نفسه لتلك "الثلاجة" قد حانتْ، فانبجس النصّ الأخير من بين صخور المراثي مُتفجّرا بتساؤلات حول وظيفة الموت ووظيفة الحياة ومواجهتهما لدى درويش وحافظ. تستطيع أن تقرأ "جدارية" محمود درويش وتأوّل نقوشها ألوانها كما شئت، لكنّك ستتفق معي في أنّها مرثيّة للتّاريخ وللذّات من ناحية وهي احتفالٌ بالحياة –من جانب آخر- حتى في لحظة الموت، أو قُل لحظة فَهم الموت. وتستطيع أن تقرأ "وجوه جمةٌ وجهي" لتتبيّن أن الشّاعر، أعني هنا أحمد حافظ، تمثّل خطاب محمود درويش، مسّته لغة درويش مسّا خفيفا، سرعان ما أفلتَ منه كما أنّه أفلت من الموت كما أفلت درويش "شعريا" لست في موقف موازنة بين النّصين ولكني أشيرُ إلى حضور الموت كتيمة أساسية. النص يطرح سؤالا حول وظيفة "الشّعر" في مجابهة الموت.. هل من وظيفة له؟
يقول الشّاعر أحمد حافظ في قصيدته (وجوه جمّة لوجهي):
في آخر الوديان ثمّ غُبار قافلةٍ
وأقدامٌ تجرّبُ أن تسير على طريقتها
وأشياءٌ تطلُّ كأنّها الغزلانُ
من أعلى مُخيّلتي
ولا حجرٌ لكي تتفجّرَ الأنهارُ
لا زيتونةٌ لأقولَ: قلبي سائغٌ للآكلينَ.
ولا سماءٌ بعدُ كي تتعلّمَ الطيرانَ أجنحتي
هُنالكَ...
حيثُ لا أحدٌ يلوّحُ أو يمدُّ يدًا
ولا يجدُ المُسافرُ أيّ لافتةِ
ولكنّ الذي يحكيه سهمٌ طائشٌ في الرّيحِ
يكفي كي يفسّرَ عابرٌ فحواه
أن:
مَن سارَ في كل اتّجاهٍ لم يصل أبدا
وظلّ مُعلّق الخُطواتِ
مزهوا برحلته القصيرةِ نحو "لا شيءٍ"
كأنْ في روحه أرجوحةٌ روّاحةٌ في كل ناحيةِ
في لُغة آتية من الحُلم، يكشف الشّاعر عن لحظة الشّتات والتمزّق التي تسبقُ الموت (السّكون) الذي يصل إليه الشّاعر بعد عذابات ومُكابدات طويلة (وضع قول امريء القيس: ولكنها نفسٌ تساقَطُ أنفسا.. كإشارة قبل بداية القصيدة) مُعترفا ببساطة أن الرحلة قصيرة نحو "لا شيء" وأن سهم الموت الطائش الذي يجيء مع الرّيح يهدده في كل لحظة، ثمّ يخالفُ توقع القارىء عندما يستحضر طائر "الشحرور" لا ليغرّد ويُغني ولكن لكي ينامَ، هي لوحة فنية أو "سينواغرافيا" لموقعة الموت حيثُ كلّ شيءٍ يذوي ويذبل:
إذن من أين أبدأ؟
كي أهيء للفراشات التي اجتمعت على فمي احتراقا هادئا
كي ينعس الشُّحرورُ فوق يديّ.
ثمّ يتقاطع مع محمود درويش في فصله اسمه عن ذاته ليخاطبه، مُدركا أنه سيموتُ بينما يحيا الاسمُ، يقول:
سأقولُ لاسمي حين يبدو واثقا كالنّهر في جريانه:
لي زهرةُ الأخطاءِ ضائعةً برائحة التأمّلِ
حولها يلتفُّ نحلٌ
باحثٌ عن حكمة مكنونةٍ في ماء نرجستي.
وكأنّه يقدّم وصيّته ويدلُّ الغائبين عليه إذ هو مُلاقيهم فيقول:
وجوهٌ جمة وجهي
وصوتي ليس لي وحدي
وأغنيتي التي هي روحي الغافي على الإيقاعِ
سوف تظل أغنيتي
ووحدي
حينما تصفرُّ أيامي
وينكسرُ الهواء قبيل آخر شهقةٍ
فرُغم أنّه حمل وجوه الآخرين متماهيا مع تجاربهم وهزائمهم ومخلصا لذكراهم، إلا أنّه يواجه الموت وحده، وهنا يتناص مع موقف درويش في قصيدة "مديح الظل العالي"، يقول درويش:
وحدي أدافع عن جدارٍ ليس لي
وحدي أدافع عن هواءً ليس لي
وحدي على سطح المدينة واقفٌ...
أَيُّوبُ ماتَ, وماتتِ العنقاءُ، وانصرفَ الصَّحابَهْ
وحدي
أراود نفسيَ الثكلى فتأبي أن تساعدني على نفسي
ووحدي
كنتُ وحدي
عندما قاومت وحدي
وحدةَ الروحِ الأخيرهْ
لكنّ خطاب درويش خطابٌ عروبيّ مؤطّر في فضاء مكاني، فهو يُدافع عن "مدينة" بينما خطاب حافظ مصوّبٌ تجاه الزّمن مُحاولا تخطّيه بموتٍ لا يُفنيه تمامًا، فرغم تآكل اسمه والعيون التي تغض عن وجهه في صورة على الجدار، ستبقى كلماته لأنه كمال قال في ختام النص:
كتابي، وهو ما ملكت يدايَ،
وكل مغفرتي..
- السّؤال في المجموعة الشعريّة:
كُتِبَ الكثير تحت لافتة "شعريّة السؤال" وهو مُهمّ وضروري لاستكشاف القصيدة، لكنني أقترحُ أن تتناول "شعرية السؤال" القصائد المبنية بشكل كامل على السّؤال، صحيح أنه ليس على الشّعر والإبداع أن يُقدّم الإجابات (وإن نجح في ذلك أحيانا) وأن عليه أن يثير الأسئلة، لكن هُناك فرقٌ بين سؤال يجيء لأغراضٍ سطحيّة مستهلكة، وبالتالي نُبرره أيضا بمبررات مُستهلكة كقولنا؛ (السؤال ينبّه المتلقي ويوقظه)! وكأن المتلقّي يظل في غيبوبة طوال قراءة النّص حتّى نطرح عليه سؤالا. هذا كلامٌ يتّسق مع الطبيعة (الشفاهية) و (الخطابية) و (المنبرية) للقصيدة القديمة وهو ملائم لقاعات الدّرس ولطلاب المدارس، لكنّ علينا أن ننشغل أكثر وأكثر بالسؤال كأداة لتشكيل النص الشّعري وكعلامة جماليّة، فضلا عن دوره في كشف بعض من فلسفة الحياة والكتابة. يُمكنني أن أستسلم لنزعة إحصائية تُجبرني على إحصاء الأسئلة في المجموعة الشعريّة ثم النّظر في اختلاف أدوات تلك الأسئلة ثم تحليل دلالات ذلك لأن دلالاته مهمّة وكثيرة في الحقيقة، لكنني لن أتعرّض لذلك إلا بذكر مواضع السؤال في المجموعة الشعريّة للتدليل على ضرورة توقفي أمامه ثمّ أقترب أكثر من تلك الأسئلة لاستكشاف دورها في النّصوص من حيث البنية والتّشكيل.
السؤال غير الاستفهام، فالسؤال أعم وأشمل لأنه ينفتح على أفق أوسع، وخاصة في ميدان الشّعر، يقول أبو هلال العسكري "الاستفهام طلب الفهم لشيءٍ تجهله أو تشك فيه، والسؤال يسأل عما يُعلم أو لا يُعلم فهو طلب الخبر وطلب الأمر والنّهي". معنى ذلك أن الاستفهام لابد له من جواب، أما السؤال فيمكن أن يقترن بجواب ويمكن أن يكون من غير جواب، ويمكن أن تكون إجابته عبر شعرية الإيحاء، فضلا عن أن الاستفهام يعتمد على الأدوات التي تعمل وفق تقنين موضوعٍ لها في أصل اللّغة، أما أدوات السّؤال فإنها تخرج على هذه التّقنين، لأن الشّاعر يُشكّل بها محورا جديدا يكون هو دالة النص(5).
لقد ورد السؤال في "قلبي ثلاجة موتى" بأدواتٍ مختلفة في صفحات: (16،18،21،27،29،30،33،39،45،47،56،67،68،73،74،90،95،96،103،106،107)
وكما قُلتُ لك، نستطيع أن نحلّل هذه الأسئلة بإحصاء أدواتها ومدى تباينها وأيّها أكثر شيوعًا لنصل إلى نتائج مُرتبطة بالتّجربة الشعريّة في مُجملها في هذا الكِتاب وعن الأحوال النفسية والشّعورية للشّاعر، لكنّني سأكتفي بتناول بعض النّماذج التي رأيتُ أنّ دورها لا يقتصر على تنبيه القارىء كما يُقال ولكنّها تمتدُّ لتكون فضاء جماليا وفلسفيا للنصّ وأداةً للخطاب الشّعري.
في قصيدته (بُكائية) ص16، يقول الشّاعر:
تعبٌ هي الأحلامُ...
من زمنٍ أسيرُ ولا محطّةَ كي تحطَ خُطايَ
أين خُطايَ أيتها الطريقُ؟
لقد قدّم الشّاعر السؤال على عكس ما يتوقّعه المتلقي، فالشّاعر لم يسأل (أين المحطّة؟) وهو المتوقّع في بعد تعبه من السّير، لكنّه فقد الخُطى نفسها ولا يعرف أين هي، وربّما هو سؤالٌ استنكاري تعبيرا عن دهشته لكثرة خُطاه التي لم تصل به إلى شيء، مشى ما مشى لكنه لم يتقدّم ولم يصل! مثل هذا السؤال يبدو مُتجاهلا القارىء وموغلا في الذاتية، لكنّ الشّاعر يعود ليوجّه السؤال لنفسه أو لنفسه وللقارىء، فيقول في قصيدته (لا أحد سيأتي) ص21:
-من أي جهةٍ تأتينا الرّيحُ؟
-من القلب.
وهُنا تطوّر دور السؤال في القصيدة لأنه جاء متبوعا بالإجابة، والإجابة (القلب) خلقت موضوعا للقصيدة، حيث تكشف لنا القراءة أن مُفردة (القلب) تكررت خمس مراتٍ، لكنّ هذه الإجابة التي قدّمها الشّاعر في البداية خلقت قصيدة مُستقلة في صورة سؤال وجواب، وجاء باقي النصّ ليُشكّل مساحات الخطر التي يواجهها الشّاعر، فتبدو (ظاهراتيا) مخاطر خارجية يُمكن دفعها بإغلاق الأبواب، لكن إعادة النّظر في النص تُشير إلى أن الخطر آت من (الداخل-القلب)، يقول الشّاعر في نفس النص بعد أن أسدل الستائر وأغلق الأبواب:
وظنوني
- أقسى من سكينٍ مسنون-
تذبحُ ديك يقيني
وتقطّع شرياني المسدودَ
لتقطُر في ماءِ الأشياءِ الراكدِ أسئلتي.
وها هو ذا يُفصح لك في هذه المقطع المجتزأ من النص أن هذا ليس سؤاله الوحيد، ربّما هو الأسهل لأنه وجد إجابته (القلب) بينما هناك أسئلة أُخرى تحوم بداخله وتُحاصره داخليا واتّخذ لها مُعادلا موضوعيا خارجيا باختيار كلمات وتراكيب لها دلالات الخوف والتيه والشتات والانتظار مثل (نار التجربة-الآبار الجافة- صحراء-ذؤبان-الذكرى-عواء...). لقد استخدم الشّاعر السؤال هُنا مُستهلا للقصيدة كي يحيك تشكيلاتها في إجابات مُحتملة بين السّطور. لعلّ ذلك يُذكّرنا بما يُسمي (الخطّاف أو الهوك أو السنّارة) في بداية العمل السردي وهو ما يحملُنا على استكمال قراءة العمل بعد أن جذبنا بخطاطيف الفضول، إذن فالشّاعر يستوردُ تقنية فنيّة من جنس أدبي آخر غير الشّعر وهي بالطّبع ليست حِكرا على غير الشّعر، فالشعريّة مفهومٌ ممتد بين أجناس الكتابة.
وليس ما ذكرتُ بمُستغربٍ إذا كان الشّاعرُ خصّ بابا من أبواب ثلاجة الموتى هو (باب السؤال) والذي ضمّ قصيدتيّ (أدوار) و (مراقبة) واتكأتا على الأسئلة المتوالية التي كوّنت بنية النص وموضوعه وانتهت القصيدتان بسؤالين! يقول في قصيدة (أدوار):
أيها الفجرُ:
من ذا الذي صبّك الآن من كأسه فوق طاولة الأرض؟
من دلق الأزرق الحلو من يده فوق مريلة الليل؟
أيّةُ محبرةٍ فذّةٍ أنجبتك؟
وأي خيالٍ تمخّضَ عنك؟
وخطّ بريشته لوحة الملكوتْ؟
أيها الفجرُ
هب أنني طائشُ الرأي!
لكنني-إذ أحدّقُ فيك وأنظر للكأس في راحتي-
أتساءلُ:
تلك نجومٌ تلألأُ.. أم حَبَبٌ يتصاعدُ؟
ما الفرق بينكما؟
النبيذُ يضيء بمصباحه ظلمة الرّوح
والفجرُ يكسرُ أبّهةَ الليلِ
يُلقي حصاةً ملوّنةً في ظلام السّكوتْ
أيها الفجرُ:
أين تروحُ إذا اصفرّ وجهكَ وقت الغروب؟
لماذا تغيبُ وراء الكواليس
ثم تعودُ إلى مسرح الأرضِ متّشحا بالسّواد؟
لماذا أرى عرشكَ المتعاظم في قبضة الليل
أوهى جدارا من العنكبوتْ؟
أيّها الفجر:
كل مساءٍ أرى الليل
يفرشُ سلطانه كالملاءةِ فوق سريركَ
ثم أراكَ
وأنت تُجيلُ خناجرَ من لهب الشّمس في قلبه..
هكذا
منذ فتّح أعينه الكونُ، ثم جرى نهرُه
منذ فكّ التحرّكُ قيد الثبوتْ
وأنا أتساءلُ في حيرةٍ:
هل سأحيا لأشهدَ أيُكما سيموت؟!
الشّاعر يقارن النّبيذ بالفجر ويرصد معركة الفجر مع الليل، وهذا الرصد للمعركة ليس رصدا عابرا لعلاقة الضوء بالظّلام أو تعاقب الليل والنّهار الذي أشار له في مُستهل هذا الباب بقول ابن المُعتز (دامَ كرُّ النّهار والليل محثوثين.. ذا منبهٌ وهذا منيمُ)، فالشّاعر منشغلٌ بفكرة الزّمن ومروره على النّاس والأشياء، لكنّه يتأمّل دور الفجر ودور الليل، أيّهما الشرير؟ وأيّهما صاحبُ الحق؟ ومن منهما يموتُ أولا؟
لاشك أنك تستطيع أن تؤوّل ذلك باعتبار الليل والفجر والنبيذ رموزا وعلامات يعبّر بها الشّاعر عن صراعات الخير والشرّ والمعرفة والجهالة أو قُل إنّه يكشفُ بتساؤلاته تلك عن حيرةٍ كُبرى للإنسان على ظهر هذه الأرض التي تدور به حول نفسها وحول الشّمس، فكيف به يجتنبُ الدّوران في أفلاك الأسئلة.
لقد شكّل السؤال بنية الخطاب الشعري هنا وعصب القصيدة كاملة وهو ما حرّك إيحاءات كثيرة غامضة أو شفافة أو واضحة في فضاء النص. وجاء السؤال الأخير ليكشف عن هشاشة الإنسان أمام الأسئلة الكُبرى وأن الوقت لن يسعفه ليُجيب عن تساؤلاته أو يجد الإجابات المقنعة (هل سأحيا لأشهد أيُّكما سيموت؟)

...........................
الاخبار الثقافية والاجتماعية والفنية والقصائد والصور والفيديوهات وغير ذلك من فنون يرجى زيارة موقع نخيل عراقي عبر الرابط التالي :-
او تحميل تطبيق نخيل
للأندرويد على الرابط التالي
لاجهزة الايفون
او تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي