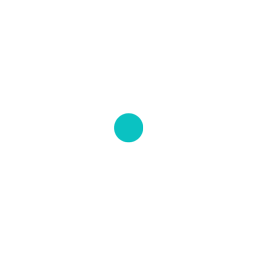
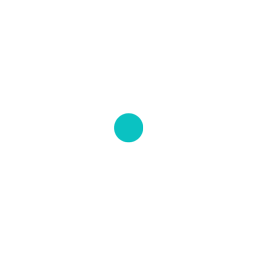
مقالات ادبية واجتماعية وفنية
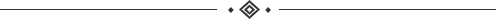
غسان زقطان || شاعر وكاتب فلسطيني
"نحن منفيون في طريقنا للمنفى، بهذا الضوء اواصل الكتابة"، هكذا فكرت وأنا أتأمل وقفة أمي على أطلال قريتها، "زكريا"، بعد غياب قسري لنصف قرن، كانت تقف هناك أمام مقام النبي زكريا صحبة ثلاث من أخواتها، كن أربع ارامل متوشحات بالسواد وصلن تلك الصبيحة الى ساحة قرية " زكريا" التي أخذت اسمها من مقام مبهم للنبي زكريا، احتفظ بصورة لتلك الوقفة، فيما بعد سأكتب قصيدة قصيرة بعنوان بسيط؛ " أربع أخوات من زكريا " وسيترجمها الشاعر العراقي سركون بولس ثم الشاعر الفلسطيني فادي جودة الى الانجليزية.
هذه الحكاية حدثت في اللحظة التي كنت أخوض فيها حوارا طويلا استغرق اسابيع طويلة مع محمود درويش في مقهى على احدى تلال رام الله، حول تعريف " العدو ".
في طريق العودة ستسألني، أمي، اذا كانت الصحفية الأميركية اليهودية التي أخذتنا بسيارتها الخاصة، البنت التي تشبه العرب، كما كانت تصفها، قادرة على معرفة مصير " رفقة "، كانت تلك خديعتي البسيطة، "اوسنات طرابلسي" لم تكن صحفية ولا اميركية كانت منتجة سينمائية اسرائيلية صديقة، وكانت سيارتها الوسيلة الوحيدة لتأمين وصول أمي بحجابها الأبيض الى القرية.
كانت تلك هي المرة الأولى عبر خمسين سنة التي تلفظ فيها اسم " رفقة "، المرة الأولى التي تدخل فيها صديقة طفولتها ومراهقتها اليهودية في القرية قبل التهجير والنكبة الى حكاياتها الكثيرة، فجأة تظهر بنت يهودية نحيفة بشعر أسود وعينين عربيتين وتبدأ بالتنفس والمشي في ذكرياتها، كما لو أنها، البنت اليهودية، تستيقظ من غيبوبة طويلة استغرقت نصف قرن وتنضم ببساطة مراهقة ومشيتها الى أولئك الذين يواصلون التحرك في بيت العائلة، الذين منحتهم أمي، الراوية الحقيقية، حقوق العيش والتنفس في ذكرياتنا.
متأخرة وصلت "رفقة " ولكنها وجدت مكانها كما هو دون أن يمس أو يجري " احتلاله " أو زراعة آخرين في انحائه، ووجدت روايتها كما تركتها لم تمس، بحيث بدت تلك الوقفة على أطلال قرية زكريا، التي منحت اسما جديدا تم اشتقاقه من اسمها الأصلي "كفار زخاريا"، أقرب الى مفتاح ، كما لو أنها "أمي" حركت، دون قصد، ايقونة سرية في الجدار المغلق وسمحت بمرور يهودية.
تماما كما فعل محمود درويش في قصائده المبكرة، " بين ريتا وعيوني بندقية " و " جندي يحلم بالزنابق البيضاء " و " سجل أنا عربي "، ثم في " عندما يبتعد " و" سيناريو أخير".
هكذا تخرج " ريتا " الخاصة بأمي تحت اسم " رفقة " وتبدأ بالتلويح لصديقتها العربية الشقراء من سفح الحرش حيث يمكن مشاهدة محطة قطار صغيرة في الوادي كانت تصل بين القدس واللد.
قلت لمحمود:
أمس قدمت أمي اعترافين قبل أن تصلي العشاء، ان لها صديقة يهودية وأنها تفتقدها، و " أنهم " أفضل منا في الزراعة.
تدخلت " سرّية مشعل "، هذا هو اسم أمي والذي أظن أنه اسم تركي لا يزال متداولا حتى بعد قرن من انتهاء الاحتلال العثماني لفلسطين، تدخلت في حوارنا الطويل درويش وأنا عندما وضعت ملاحظتين سريعتين قبل أن تنهض لصلاة العشاء، وقبل أن تقرر العودة الى بيتها في عمان شرق نهر الأردن. لأنها لا تريد أن تكون لاجئة في رام الله أيضا، ولأن كل البلاد ستكون منفى بعد هجرتها من بيتها في " زكريا ".
عندما تركت المنفى الذي اقترحته عليها عائدة الى منفاها كانت قد أضافت شخصية جديدة ورئيسية الى حكاياتها، " رفقة "، وكانت معنية تماما بمصيرها، وبدا أنها قررت وبشكل نهائي أن تفتح ذلك الباب المغلق في حكايتها.
لماذا خرجتم من البلاد سألتها
كنا خائفين، كانوا يقتلون الناس ويحرقون القرى، تقول "سرية مشعل".
ثمة ما يشبه الانفصام هنا، فعلى الأرض وفي " المخيلة" اليومية الشعبية التي تغذيها غايات اليوم وحاجاته، يتحرك " الآخر " ويتحدث بلغته، وينادى باسمه الشخصي، الآخر الذي يصبح " رب العمل "، و" تاجر الجملة " و" صاحب المصنع " ومطلق النار " و"المستوطن " و"العنصري" و"المتدين الذي يستعير أدعية توراتية للقضاء على " العرب "، ولكنه يعود الى " جماعته " وغموضه في النص المكتوب.
لقد استطاعت الحياة اليومية بقسوتها تحت الاحتلال أن تفكك العدو/ الآخر وتحوله الى آخرين، وان تمنحه في التفاصيل الصغيرة صفات متعددة، وأن تصنفه دون أن تعفيه من الأرضية التي نشأت عليها " العلاقة " وهي الاحتلال، ولكنها اضافت الى تلك الأرضية صفات متعددة ومختلفة أنسنته تماما، بينما ما زال العدو يتحرك في النص المكتوب داخل كتلته المغلقة.
من هنا، في هذه المسافة المحرمة بين وعي الحياة اليومية وعاميتها، ووعي النص المكتوب بلغة كلاسيكية، "الفصحى"، تشكل مشروع درويش فيما يشبه تحديا مركزيا لشروط السياسي في المشهد الشعري الفلسطيني والعربي.
كان ذلك واضحا في كل مرحلة من مراحل منجزه بما فيها مرحلة البدايات التي ارتبطت بالمقاومة وتداخلت مع الأيديولوجيا. جغرافيا البدايات وزاوية التناول منحت تلك القصائد بنبرتها الواضحة والقاموس الجديد الذي يخاطب العدو/ الآخر عبر تماس جسدي، حضورها وتأثيرها الذي لا يزال متصلا الى الآن.
سيذهب محمود أبعد في مشروعه في المراحل اللاحقة، وسيضيف مناطق محرمة جديدة الى حقله، مستفيدا من حصانته في الوعي الجمعي الفلسطيني والعربي، ومن الجغرافيا ومعرفته الخاصة بثقافة الآخر واحتكاكه اليومي بمجتمع طارىء، يخفي قلقه الوجودي تحت قناع الضحية، ويستمد احداث روايته من خليط غيبي ومادي، في تلك النصوص قدم محمود هويته بقوة ووضوح، ولكنه جرد "العدو" من اكثريته واستدرجه كفرد فيما يشبه اكتشاف الشق في الجدار، فظهرت نصوصه الجديدة تماما على الذائقة العربية، مثل " ريتا "أو " جندي يحلم بالزنابق البيضاء "، وهي حوارية مع جندي اسرائيلي ظهرت في احدى مجموعاته المبكرة، الحوار بسيط ومؤلم ويخلو تماما من محاولة تنظيف الجندي من دماء ضحاياه، يتحرك الحوار في مستويين الواقع والحلم، واقع القتل الذي يحسب بعدد الأوسمة، لقد قتلت كثيرين ولكنهم لم يمنحوني سوى وسام واحد، يقول الجندي "المطيع" وهو يخاطب الشاعر باسمه المجرد، "يا صاحبي محمود"، وحلم الجندي، غير المتحقق، بالخروج من كل هذا، لقد استطاع في ضربة واحدة أن يؤنسن العدو ويعيده الى عاديته وفي نفس الوقت أن يدرب الذائقة العربية على تقبل عدو يمتلك هيئة بشرية ويطلق النار.
" بين ريتا وعيوني بندقية" تحولت على يد الموسيقي اللبناني " مارسيل خليفة " الى أغنية حب عذبة وحزينة، ورغم انها ولدت، الأغنية، خلال الحرب الأهلية اللبنانية القاسية في السبعينيات من القرن الماضي، وتحت مظلة منظمة التحرير نفسها التي كانت ضمن أطراف تلك الحرب، الا أن الأغنية تحولت، وهذا غريب فعلا، الى أيقونة حقيقية لليسار العربي وواصلت سيرها الى الآن عابرة لأكثر من جيل.
حكاية الحب المستحيلة بين البنت اليهودية، المجندة الجميلة " ريتا " والشاعر الفلسطيني ذهبت أبعد مما خطط لها، وبما يشبه اتفاقا واصل محبوها التأثر بها دون الإشارة الى هوية الفتاة.
حتى في نصوص مبكرة مثل " سجل أنا عربي " استطاع أن يقدم صورة للعدو المنتصر الذي لن ينجز انتصاره على الهوية، " العدو المنتصر " لم يكن موجودا في النص الفلسطيني والعربي بالوضوح الذي قدمه درويش، حتى فيما بعد عندما تتالت " انتصارات " العدو واصل الشعر الفلسطيني الحديث عن عدو بلا ملامح حقيقية بلا حضور جسدي وبلا ظل، عدو ميت ولكنه يواصل انتصاره خارج القصيدة.
او الحديث عن الخسارة التي تسبب بها " شبح " بمرتبة "عدو".
درويش ذهب مباشرة الى "عدوه" وفككه ومنحه ملامح، وضوح العدو سينعكس على وضوح المقاوم وسيمنح الصراع بعدا واقعيا يفتقر له، هذه الواقعية الضرورية لبناء الحوار وتحريكه نحو مناطق مكشوفة بجسد انساني وعينين مبصرتين، وسيسمح برؤيته، العدو، وتتبعه وتأمله، وسيسمح في نفس الوقت بتحول الشاعر، درويش هنا، الى " شاعر طروادي "، وهو ما فعله درويش، وما فعلته " سرية مشعل "، أمي، عندما فتحت الباب بعد نصف قرن من "النفي المتبادل" لتحرر "رفقة" من الكتلة الغامضة والمغلقة ل"العدو" وتشير لها لتدخل وتلتحق بذكرياتنا.
سيكون من السهل هزيمة شبح وتحميله وشحنه بأسباب الخسارة ومعاذيرها والحصول على بطولة ملائمة عبر التجاهل والمبالغة، ولكن سيكون صعبا بقدر ما هو واقعي مواجهة "عدو" حقيقي مادي يمتلك تناقضات ونزعات انسانيه بمعانيها المركبة، هنا تصبح المعرفة والثقافة هي البنية التحتية للنص بديلا عن البلاغة السائدة والتي تخفي عجزها وهزائمها وراء حيلة اللغة.
محاولة تغييب الآخر/ العدو هي محاولة لتفادي المعرفة، هو انتحار معرفي بأدوات سياسية. العدو هو جزء من ثقافتنا ومن مصادرها، هو من مكونات الهوية التي ستبقى ناقصة بدونه ومن مصادر المنفى أيضا، وهو موجود بقوة رغم آليات التجاهل، يأتي به الصراع وتأتي به الهزائم والخسارات والمواجهة، هو الآداة الرئيسية التي نمت عليها ثقافة الاستبداد وتسلحت بها لتأبيد قبضتها على حياة الناس.
في استحضاره، وهو ضروري، يمكن الذهاب ابعد في قراءة وجودنا تحت ضوء المواجهة، الصراع يثقفنا ويغيرنا في نفس الوقت، يأخذ ويمنح، يكشف مناطق الضعف ومواطن القوة والثغرات في الجدار، نحن لسنا انفسنا بعد كل جولة، علينا أن نرى ما أصبحنا عليه وهذا لن يتم الا بتعميق المعرفة بالآخر.
الآخر/ العدو، هو امتداد عضوي للمسكوت عنه في ثقافتنا، الدين، السلطة،الجنس.
ثمة اضافات كانت حاضرة في كل مراحل مشروع درويش، اضافات متكئة على معرفة مختلفة وثقافة مختلفة، لعل أهمها هو معرفته ب "الآخر"، ونزوعه الواضح لخلق حوار وتعميق هذا الحوار ونقله الى مطارح جديدة، هكذا خرج من المشهد الرومانسي البسيط ل "جندي يحلم بالزنابق البييضاء" او " بين ريتا وعيوني بندقية" الى مشهد " العدو" في قصيدته "عندما يبتعد" في مجموعته اللافتة "لماذا تركت الحصان وحيدا" ، الى ابنة "العدو" الذي أصبح أبا، والى قصيدته "شتاء ريتا الطويل" في مجموعة "أحد عشر كوكبا"، هذا الحوار هو الذي اوصله الى قصيدته المتأخرة " سيناريو جاهز " التي ترك نهاياتها مفتوحة على " شاعر آخر ليتابع المشهد، مشهد القاتل والقتيل عالقان في حفرة واحدة.
بموازاة ذلك تماما كان معنيا بفتح حوار داخلي مؤسس على اسئلة تأملية، لا تبحث عن اجابات، مع مجايله ادوارد سعيد، هنا اختار درويش عنوان "طباق" لقصيدته، وهو ترجمة للمصطلح الذي نحته سعيد، واختار لبناء المشهد فكرة الجسر بدلالاتها المفتوحة على الاحتمالات وكلاسيكيتها المأمونة.
ثمة ما يغوي هنا لدى الكثيرين في خلق مقارنة بين درويش وشعراء اسرائيليين مثل "بياليك"، لا أدري مدى دقة اعتباره اسرائيليا، وعلى وجه الخصوص الشاعر الإسرائيلي " ايهودا أميخاي" الذي لم يخف درويش اعجابه به في أكثر من مناسبة، يقودهم في ذلك الفهم الخارجي والبسيط للرواية السياسية، تلك التي رواها سياسيون من الطرفين، فكليهما جسّدا في مرحلة ما الهوية الوطنية لشعبيهما، ودافعا عن الرواية السائدة وأضافا لها، بالنسبة لي أرى أن هذه المقارنة وجدت أيضا مادتها في فترة السبعينيات، عندما استقرت "اسرائيل" كدولة منتصرة محاطة بأساطير النصر بعد حرب الأيام الستة العجيبة، دون أن تتخلى عن ميزة احتكار دور " الضحية "، وتكرّس نهوض الحركة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن وصاية النظام العربي السياسي، لقد سمحت الهزيمة، وهي مفارقة فعلا، للهوية الفلسطينية بالخروج من معطف النظام العربي، وهي هوية ساهم في اعادة صياغتها والحفاظ عليها وبعثها في اطار " ثورة منفيين " المثقفون الفلسطينيون وفي مقدمتهم، دون شك، ادوارد سعيد ومحمود درويش.
ولكن منذ صدور كتابه اللافت، " لماذا تركت الحصان وحيدا " تجاوز درويش المقارنة مع "أميخاي"و "بياليك" واتخذ منعطفا خاصا، كان قد مهد له عبر مجموعاته " هي أغنية " و" ورد أقل " وعمقه في التسعينيات وحتى وفاته في هيوستن في العام 2008.
بدت تلك المجموعة " لماذا تركت الحصان وحيدا " اقرب الى اعادات على ضوء يشبه الحكمة، لقد اختار شخوصه الذين صعد معهم في الستينيات والسبعينيات، ريتا والجد والأم والعدو على وجه الخصوص، كما ظهر الأب الذي كان متواريا، ولكنهم وصلوا بهيئات جديدة وأفكار اكثر هدوءا وحكمة.
هذا يأخذني الى نهايات صيف 2007 حين حل محمود درويش ضيفاً على "أمسيات ستروغا الشعرية" في مقدونيا، المهرجان الأعرق والأقدم في العالم، كان ذلك آخر مهرجان شعري يشارك فيه قبل أمسيته الفرنسية التي أحياها وهو في طريقه إلى "هيوستن"، يحبون هنا، في ستروغا، أن يتذكروا ذلك، إنه كان هنا في ذلك الصيف الأخير بعد أن توّجه المهرجان بجائزته الثمينة "الإكليل الذهبي" التي تمنح سنوياً لشاعر مؤثر من العالم.
من تقاليد الجائزة أن يزرع حامل الإكليل شجرة في "حديقة الشعراء" حيث توضع على الأرض لوحة برونزية تحمل اسم الشاعر وتاريخ حصوله على الجائزة، هناك، في الحديقة، ترتفع الآن 50 شجرة تحمل أسماء الشعراء من "بابلو نيرودا" في تشيلي حتى "بي داو" في الصين مروراً بالأمريكي "غينسبرغ " والإسرائيلي " يهودا أميخاي " والسوري "أدونيس" والروسي "يفتشنكو" إلى السويدي" ترانسترومر".
في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاحتفال في الحديقة سأل أحد الصحفيين محمود درويش، يقول الشاعر والمترجم المقدوني "نيكولا مازديروف":
كيف تشعر وأنت تزرع شجرة غير بعيد عن شجرة تحمل اسم الشاعر الإسرائيلي "ايهودا عميخاي"؟
أجاب محمود:
لست قلقاً من ذلك، الشجرة لا تقتل شجرة...
أكثر من مرة استمعت لهذه الرواية بصيغ مختلفة ومن أشخاص مختلفين، "مازديروف" كان شاهداً على الحكاية التي اتخذت شكل الحادثة فيما بعد، ولكنها احتفظت جميعها، الروايات، بنفس النهاية الحاسمة:
الشجرة لا تقتل شجرة.
اذا كان لا بد من المقارنة او البحث عن تقاطعات مع شاعر " منفي " مشغول بأسئلة الهوية العميقة، فلا شك انني سأختار " بول تسيلان".

...........................
الاخبار الثقافية والاجتماعية والفنية والقصائد والصور والفيديوهات وغير ذلك من فنون يرجى زيارة موقع نخيل عراقي عبر الرابط التالي :-
او تحميل تطبيق نخيل
للأندرويد على الرابط التالي
لاجهزة الايفون
او تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي