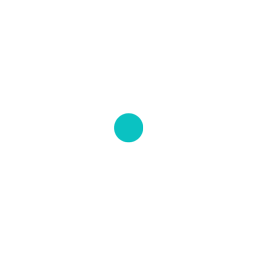
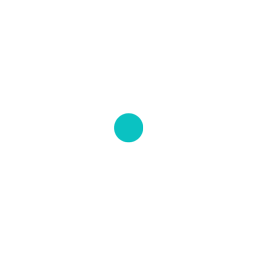
يعنى بالسرد القصصي والروائي
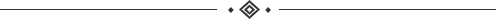

آسيا رحاحلية/ كاتبة جزائرية
كلما أغمض عينيّ تحضرني صورتها البهية حين تدنو منا، لحظاتٍ فقط قبل أن يسلمنا النوم إلى حضن الأحلام و تزرع وجهي ثم وجه زينب بقبلاتها المشبعة بالصدق .
تشير بإبهامها إلى عينيها فنبتسم .
نفهم ما تعنيه قبل أن تنطق العبارة ... " أنتما عيناي ...أنتِ اليسرى ، و أنتِ اليمنى ".
يومها كان للدنيا طعم السكر و حياتي ضحكة كبيرة ، ساحرة ، لها مزاج الشمس حين تستفرد بكبد السماء ، و أمي ملاك فوق الأرض ، قدّيسة ، أميرة ، حبّ العمر الأوّل و الوحيد .
كنتُ مرحة رغم خجلي و انطوائي ، و لي جناحان صغيران من حرير ، يحلّقان بي عاليا حين يتزوّد يومي من عينيها أو يتلقّف قلبي شعاع ابتسامتها .
ترى كم سيحتاج عمري من العمر لكي أتقبّل سقوطي الرهيب بعدما رفعتها و ارتفعت بها إلى تخوم النجوم ؟
أعرف أنّه كلما كان الإرتفاع أعلى كان السقوط أشدّ وقعة ، و لكن ، أليس من المفروض أنّ الحقيقة تصحّح خطواتنا ؟ تثبّتنا أكثر؟ أليست الحقيقة شكلا من أشكال القوّة و الحرية ، الجوهر الذي قد نقضي العمر مهووسين بالوصول اليه و الفوز به ؟
لا أدري . هراء كل النظريات التي قرأت . لم تعلّمني الكتب شيئا في النهاية ، أبدا ، لا شيء و لا حتى القدرة على أن أستبين أيهما أرحم ، حرير الوهم أم شوك الحقيقة ؟ ثبات الشك أم اهتزاز اليقين ؟
مؤلمٌ ...قاتلٌ هذا الإحساس باليتم. رئتي يغلّفها الجليد ، صدري يعتصره الألم . عقلي تتمزّقه الحيرة و الذّهول.
ضائعة أنا و خائفة و هشّة ، مثل نبتة في العراء فاجأها الإعصار .
لا أثر لجناحيّ الجميلين ، و الضباب ، رماديٌّ كثيفٌ يحجب عني عينيها و ... العالم بعد أن حوصرتُ داخل مربّع الشتات ، و انقلبت حياتي مائة و ثمانين درجة .
ليتني بقيت عمياء و لم أكتشف الأمر ... أومن بكل ما تقوله و تفعله . صعب أن تفقد فجأة إيمانك بما عشت عمرك كله واثقا منه ، مسنودا به . ترى ، ماذا هناك أيضا ؟ أيّة أمور أخرى سوف تنكشف لي ؟ إذا كان الشك يؤدي إلى الحقيقة فإنّ الحقيقة تؤدي إلى حقائق ، ربما أقل فظاعة ، و لكن مرّة و بشعة .
الحقيقة لا تأتي مكتملة دائما ، لا تكون سوى الجزء الناتئ من جبل الجليد ،الهزّة التي تصاحبها ارتدادات .
ما يؤلمني حقا الآن هو عجزي عن فهم شعوري نحوها بعد أن رأيتها أمامي عارية تماما ، بلا مساحيق .
أمازلت أحبها ؟ هل أنا أكرهها ؟ هل يوجد شعور وسط بين الحب و البغض ؟
ليتني أستطيع كرهها . لا أقدر، حتى لو أردت ذلك . لا أقدر .
حالما انقشع الوهم ، بدت لي كل الصور جليّة ، واضحة . ها هي تنفرط من حبل الزيف كحبات العقد ، واحدة تلو الأخرى ...إنفاقها ببذخ غير معقول على الملابس الأنيقة الغالية الثمن ، المجوهرات الثمينة التي تقتنيها متعلّلة في كل مرّة بكذبة ما ... منحة قبضتها من المستشفى ، سلفة حصلت عليها باتفاق مع مجموعة من الزميلات الممرضات ، تعويض جديد من الدولة على خلفية مقتل أبي ، ثم حرصها الغريب على ألاّ نزورها أبدا في المستشفى ، أبدا ، مهما حدث ... و تلك المكالمات الهاتفية المريبة . لازلت أذكر الليلة التي استيقظت فيها على صوتها وهي تصرخ في الهاتف و تهدّد . " إلا بناتي ! إياك أن تقترب من بناتي ! " ...
في الصباح سألتها عن أمر تلك المكالمة فاستغربت و أنكرت ، " عزيزتي ، كنت تهذين بسبب الحمى " . صحيح كنت مريضة ليلتها و لكني لم أكن أهذي ، إنّما كذّبت نفسي و صدّقتها . أمي لا تكذب . أبدا . أمي دائما على حق . حتى الشكوك حين يحدث و تطوف برأسي ، و يغشى طنينها عقلي ، مزلزلا و عاصفا، كانت تبعثرها صيحة واحدة من عمق باطني...ما هذا ؟ كيف أجرؤ ؟ مستحيل ... إلا أمي !
كتمت الأمر عن زينب . خفت عليها من الصدمة . "أختك هي صديقتك الوحيدة . كونا معا دائما ، متلاحمتين و إذا كان لابد لإحداكما أن تموت من أجل الأخرى فلتمتْ . " لم أنس هذه العبارة أبدا.
لقّنتنيها أمي منذ صغري كما تُلقّن الشهادة .
أكيد ... كنت سأموت من أجل زينب و لكن أمي قتلتني !
زينب تصغرني بأربع سنوات و هي صديقتي الوحيدة . في الحقيقة ، لم أفلح أبدا في نسج صداقة مع أية فتاة أو شاب . في طفولتي الأولى و حتى سن المراهقة ، كنت أعزو ذلك إلى شخصيتي الانطوائية و أيضا ظروف أبي المهنية . كان دركيّا ، لا نكاد نستقر في مكان و نألفه حتى يأتي القرار بنقله الى مكان آخر . و أضطر في كل مرّة الى الرحيل . أترك مدرستي و ذكرياتي و بعضا من روحي . كم كان ذلك محرجا و صعبا !
من حوالي سنتين استقر بنا المقام في هذه المدينة الصغيرة التي تبعد أميالا فقط عن مدينة ساحلية كبيرة ..منحتنا الدولة تعويضا ، شقة و مبلغا ماليا بعد أن اغتالت يد الإرهاب أبي و نسف حزام ناسف فرحتنا و سعادتنا .
مسحت أمي عن جبيني خطوط الحزن . ملأت الفراغ الذي تركه أبي و استطاعت بفضل بعض الوسطاء و شهادة في التمريض أن تحصل على عمل ليلي في المستشفى الجامعي في المدينة الكبيرة .
تستقل تاكسي كل مساء وتغادر للعمل و لا تعود إلا مع الفجر منهكة ..
انغلقت الدائرة علينا نحن الثلاثة ...أمي و زينب و أنا . اعتزلنا الناس لأنهم " يغارون منكما و يحسدوننا لأننا الأفضل و الأجمل و الأرقى " .. صرت أعامل الناس باحتقار . كرهتهم . مسّني الكِبْر و بتُّ مغرورة ، متعجرفة ، أنظر إلي البشر من فوق ، أراهم كالذباب . الناس أغبياء و أشرار و تافهون ، لا يستحقّون صداقتي ..و أنا لست بحاجة إليهم مادامت معي أمي و أختي .
ظل الحال كذلك إلى أن تعرّفت على سارة ، في الأشهر الأخيرة من نهاية دراستي الجامعية . كنت مجبرة على الحديث إليها و التقرّب منها . و كان لابد أن نلتقي بانتظام للعمل معا على مذكّرة التخرّج .
و في يوم دعوتها إلى زيارتي في البيت لكي نتّفق على الخطوط العريضة للبحث .
و لكني ما كدت أتلفّظ باسم الحي حتى انتفضت سارة كأنّ عقربا لدغتها :
- ماذا قلتِ ؟ تقطنين ذلك الحيّ ؟ حيث تسكن تلك المرأة ؟
- من تقصدين ؟ أية امرأة ؟
- غير معقول ...ألا تعلمين ؟! منذ متى تسكنين هناك ؟
- منذ...منذ سنتين تقريبا و بضعة أشهر . لماذا ؟
- غريبة ! و لم تسمعي عنها ؟
- أسمع ماذا ؟ أفصحي سارة أرجوك !
- في ذلك الحي تقطن / ........ / حدّثتني عنها أمي ..أرملة شابة و أم لبنتين . توهم الجميع بأنّها ممرضة و تشتغل في المستشفى الجامعي بينما في الحقيقة هي ...هي ..
تتلفّت سارة يمينا ثم يسارا كمن سيلقي بقنبلة ..
- حسنا اقتربي لأهمسَ في أذنك .
دمدم همسها في أذني ، و في رأسي سقط الليل و الصقيع.